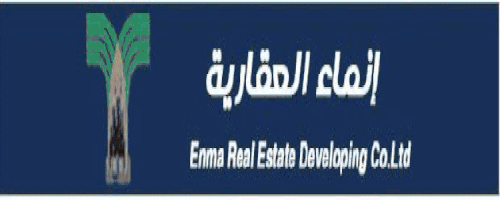(الزينبيات) عقدة في شبكة أكبر: هندسة الخوف في وعي الحوثية
كشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، المرفوع إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2025، عن مشهد بالغ الخطورة في بنية السلطة الحوثية، إذ لم تعد انتهاكاتها الأمنية محصورة في البعد العسكري أو السياسي، بل امتدت إلى إعادة تشكيل المجتمع عبر أدوات جديدة للضبط والسيطرة.
أخطر ما ورد في التقرير هو ما يتعلّق بالوحدة النسائية المسماة “الزينبيات”، التي تم دمجها رسمياً ضمن أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة في مناطق سيطرة الجماعة، لتتحول إلى ذراع أمنية فاعلة تشارك في الاعتقال والمراقبة وإدارة السجون، بل وفي تجنيد الأطفال.
هذا التوصيف لا يقدّم فقط مشهداً توثيقياً لانتهاكات صارخة، بل يفتح باباً أوسع لسؤال فلسفي عن معنى السلطة حين تُعاد صياغتها داخل المجتمع لا فوقه.
أعتقد في جوهر هذا التكوين، يمكن قراءة ظاهرة “الزينبيات” بوصفها أداة لإعادة إنتاج العنف في هيئة جديدة. فحين تُسند إلى النساء مهام القمع، لا يقتصر الأمر على توظيف الجسد الأنثوي في العمل الأمني، بل على إضفاء غطاء رمزي على فعل السلطة نفسها. هنا، أتصور أن العنف يتحوّل إلى “قيمة أخلاقية” مبرّرة داخل النسق الحوثي، تُمارسها النساء باسم العقيدة، ويُبرَّر بها انتهاك النساء الأخريات باسم “حماية المجتمع”.
بهذا المعنى، لا يكون دور “الزينبيات” وظيفة تنفيذية فحسب، بل تجسيداً لتحوّل أعمق في مفهوم السلطة من ممارسة القوة إلى صناعة الطاعة، ومن ضبط السلوك الخارجي إلى هندسة الوعي الداخلي.
في الواقع إنّ هذا الانزياح الخطير من السلطة كهيمنة إلى السلطة كإقناع أو “تطويع”، هو ما يجعل الملف الأخلاقي أخطر من الملف الأمني. فالمرأة التي تتحول إلى أداة في جهاز المراقبة، تُسلب وعيها مرتين: مرة بوصفها خاضعة لبنية سلطوية مغلقة، ومرة بوصفها أداة لإخضاع غيرها.
وعليه يفقد المجتمع آخر خطوطه الدفاعية، لأن الجهة المفترض أن تكون صوت الرحمة أو الضمير، تُعاد صياغتها لتصبح جزءً من هندسة الخوف.
إنها في اعتقادي ليست فقط إعادة توظيف للمرأة، بل إعادة تعريف للأنوثة بوصفها وظيفة أيديولوجية داخل مشروع يرى في الإنسان وسيلة لضمان السيطرة لا شريكاً في الفعل التاريخي.
فضلاً عن ذلك؛ يتجاوز هذا التحوّل حدوده المحلية إلى بعد أوسع يتصل بطبيعة المشاريع العقائدية التي تستند إلى الأدلجة الدينية لتبرير العنف. فالسلطة الحوثية، كما يشير التقرير، لا تكتفي بالتحكم في أدواتها العسكرية، بل تبني منظومة معقّدة من العلاقات تمتد إلى شبكات تهريب، واتصالات استخباراتية، وتنسيقات مع جماعات مسلّحة في الصومال واليمن. ما يعني أن “الزينبيات” ليست وحدة معزولة، بل عقدة في شبكة أكبر تُعيد إنتاج نموذج “الدولة المؤدلجة” التي تذيب الحدود بين الأمني والعقائدي، وتجعل العنف ممارسة يومية مشروعة داخل بنية المجتمع ذاته.
وعند هذه النقطة، يصبح الحديث عن “الزينبيات” ليس توصيفاً لحالة أمنية، بل تشخيصاً لتحوّل ثقافي أعمق: إذ تغدو السيطرة على العقول أهم من السيطرة على الأرض. فالخطر الحقيقي في تصوري لا يكمن في أجهزة الصعق الكهربائي بقدر ما يكمن في “الشرعية النفسية” التي تُمنح للعنف باسم العقيدة.
لذلك، فإن مقاومة هذا النمط من السلطة لا تكون بالسلاح فقط، بل بفضح آلياته الفكرية وإعادة الاعتبار للوعي بوصفه الفضاء الأول للمقاومة. فحين يتحرّر الوعي من الخوف، تنهار منظومات القمع مهما بدت متماسكة، لأن السلطة التي تُبنى على الوهم لا تصمد أمام معرفة تستعيد الإنسان من بين أنقاض الأيديولوجيا.