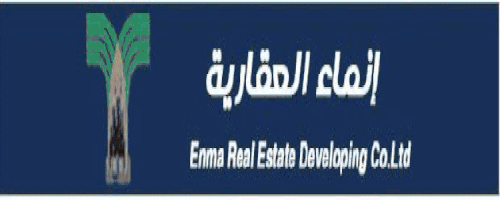الدولة والدين فى الوطن العربى «الحالة المصرية»
موضوع هذه الورقة هو النظر فى مسألة الدين والدولة فى الوطن العربى، عن حالة مصر بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، من حيث مكانة الدين وأثره فى النظام المصرى، وفى إطار ما هو مدرك من صعود التيار السياسى الإسلامى إلى السلطة.
والسؤال الذى ينبغى أن يطرح فى البداية هو: التفكر فيما إذا كانت الأوضاع السياسية قد أنتجت بعد الثورة نظامها السياسى، أم أنه نظام لا يزال فى طور التخليق والإيجاد؟
والحاصل أن هذا السؤال المبدئى لم تتحدد إيجابته بعد أو بعبارة أدق لم تكتمل إجابته بعد، لأن النظام المصرى بعد الثورة لم تكتمل ملامحه وتوازناته بعد، وإن كان يسير فى هذا الطريق، وهو يتحدد عبر عملية الصراع السياسى الذى يجرى الآن بين تيارات مختلفة وقوى سياسية متباينة، ونحن فى مجرى الثورة، وحلقات أحداثها لا تزال موصولة، وأقصى ما نستطيع استخلاصه الآن هو أن نتبين حقيقة الأوضاع الجارية والقوى السياسية التى تتعامل مع بعضها البعض بالصراع أحيانا وبالجدال والمحاورة أحيانا أخرى، وهى القوى التى نتجت عن الوضع الثورى خلال العام ونصف العام المنصرمين منذ 25 يناير 2011.
وأنا أكتب فى هذا الموضوع من وجهة نظرى عن الحالة المصرية، وهى وجهة نظر أكاد أقول إنها متبلورة فى عدد من المكونات الفكرية المحيطة بالموضوع بالنسبة للدولة المصرية وأثرها فى المجتمع وأثر الجماعة الوطنية فيها. وبالنسبة للدين كمرجعية تعبر عن الحالة الثقافية السائدة بالنسبة للمصريين.
وأشير إلى هذه المسألة لأن النقاط الإرشادية التى وردت فى خطاب المركز بإسناد هذا الموضوع لى، لم تكتف فيما ظننت بأن تبين حدوده حتى لا يتداخل مع موضوعات أخرى مطروحة فى الندوة، ولكنها أكاد أقول إنها عكست وجهة نظر عن الموضوع ذاته من حيث تمام سيطرة تيار معين على الدولة، ومن حيث وجهة النظر الدينية التى يتبناها.
وإن الصورة فى ظنى من هذين الطرفين أكثر تعقيدا وتركيبا وأكثر تداخلا وأبعد عن الحسم فى إمكان الاستنتاج غير الظنى.
(2)
نحن نعلم أن أية ثورة تكون عادة بحشد قواها للإطاحة بالنظام القائم، ويشارك فى ذلك عادة قوى سياسية متباينة الأهداف، وقد تكون متخالفة فى تشكلها الثقافى العام أيضا، لكن يجمعها التصميم على إسقاط النظام القائم، والنظام المذكور يتمثل فى أشخاص الحاكمين وفى التنظيمات الحاكمة، وفى تشكيلات النخب السياسية التى قام هذا النظام فى إطار توازنات تقوم بينها. وإن أى نظام سياسى يتشكل فى تبلوره المستقر من أشخاص وتنظيمات وتوازنات نخب ويدور فى إطار العلاقات بين بعضها البعض.
وإن هذه المرحلة من مراحل الثورة، الخاصة بالتقاء القوى الثورية على إسقاط النظام القائم، عادة ما تكون أسهل مما بعدها، لأن القوى التى تقوم بالثورة وتتجمع من أجل هذا الإنجاز تكون رغم التباينات السياسية بينها، تكون تلاقت على عقيدة أن النظام المراد إسقاطه قد صار يقف حجر عثرة كحائط صد مانع فى وجه أى تعديل أو تغيير ترى كل من هذه القوى وجوب تحققه لصالح الجماعة السياسية ولإنجاز حاجاتها الملحة، مع تباين هذه القوى فى نظرها لصالح الجماعة ولحاجاتها الملحة.
ومفاد أن الحراك الثورى أزاح النظام السابق، لا يعنى أنه حطم جميع عناصر وجوده وهياكله الاجتماعية والتنظيمية، لكن يتحقق الجانب الأهم من الإزاحة بتقويض هياكل النظام وخلخلة التوازنات والعلاقات الاجتماعية والسياسية بين أشخاصه ونخبه حسبما كانت قائمة فيما قبل الثورة، وتكون الخلخلة بالقدر الذى يفقد النظام القدرة على السيطرة على الأوضاع السياسية.
وبهذه الإطاحة أو بهذه الخلخلة المفقدة للسيطرة يكون قد ظهر فراغ فى الحكم، فراغ سياسى وتنظيمى، مما يستدعى أن تحل محله قوة سياسية أو قوى أخرى، وإن القاعدة التى تكاد تكون أقرب ما يكون إلى القانون فى السياسة، هى أن من أزاح النظام السابق يكون هو المرشح للحلول محله، سواء كان قوة واحدة أو قوى متعددة تشاركت فى أعمال الإزاحة، لكن الصورة فى الواقع لا تقوم بهذه البساطة التى يعبر بها هذا التعميم المجرد من ذكر القاعدة، وذلك على تفصيلات يتعين الإشارة إلى بعض عناصرها العامة.
فإن القوة السياسية المعنية هنا يقصد بها الجماعة المنظمة، ويقصد بالتنظيم أن يكون لها القدرة على جمع المعلومات واتخاذ قرار بشأنها فيما تواجه من أمور السياسة الجارية وذلك فى إطار ما اجتمعت عليه من فكر وأهداف، وأن لها فى ذات الوقت من شبكات التنظيم البشرى ما يمكنها من إنفاذ هذا القرار المتخذ منها، وذلك بما يؤثر فى مجرى الأحداث بالفاعلية المعتبرة، وذلك سواء بتحريك شعبى منظم، أو بتحريك تنظيمات أخرى نقابية أو اجتماعية، أو بتحريك أجهزة من أجهزة الدولة، أو بإشاعة جملة من الأوضاع تؤثر فى سياسات الآخرين وتصرفاتهم بالتزكية أو التفكيك لها.
ومع تعدد القوى التى تكون شاركت فى أفعال إزاحة النظام السابق، يتعين تقدير حجم التأثيرات التى شاركت فيها كل من هذه القوى، وهذا الحجم يقاس بالنسبة لكل منها حسب تأثيره فى أفعال الإزاحة، من حيث القوة السياسية المعنية شعبيا مثل الأحزاب والجماعات، أو من حيث موضع هذه القوة السياسية من دوائر الحكم فى الدولة بما يجعل لحركتها أثر فعال فى سير الأحداث مثل الأجهزة العسكرية وغيرها، أو من حيث الأدوات التى يكون فى الإمكان استخدامها للتأثير على الرأى العام وردود فعله مثل وسائل الإعلام، أو من حيث القدرة المادية مثل رجال الأعمال النشطين فى العمل السياسى، باستخدام ما يحوزونه من إمكانات مادية للتأثير فى أى من القوى السابقة.
وإن حصيلة كل من هذه القوى السابقة فى الفعل الثورى المزيح للنظام السابق تكون لها حسابها من بعد فى المشاركة فى النظام الجديد، وتتأثر أوضاع المشاركة فى النظام الجديد بحسب التوازنات التى تنتج عن الأحجام النسبية لكل من هذه القوى فى علاقاتها بعضها البعض.
وثمة عنصر آخر يعقد الصورة السابقة، هو يرد من أن الحالة الثورية التى تكون تفجرت فى ظروف سخط شعبى عام، هذه الحالة تكون مع الفعل الثورى للجماعات المنظمة، تكون جذبت أعدادا هائلة من الجماهير غير المنظمة، وهى أعداد وأحجام جماهيرية قد تفوق كثيرا جدا قدرة القوى المنظمة التى أشعلت الثورة أو حركات أحداثها الأولى، وهى تكون جماهير لم تأتِ من قنوات العمل التنظيمى، وبعضها يرد من جماعات منظمة فى غير العمل السياسى، ولكنها تحولت تلقائيا مع المد الثورى لاستخدام قنواتها التنظيمية الاجتماعية أو النقابية أو الثقافية أو الخدمية للعمل الثورى، وهؤلاء جميعا بحركاتهم التلقائية الحاشدة يصير لها فضل كبير فى إزاحة النظام السياسى المستهدف إسقاطه من قبل الثوار، لكن هذه القوة التلقائية المضافة مع أثرها الكبير فى الإنجاز السياسى فى إسقاط النظام لا يكون فى استطاعتها المشاركة فى التشكيلات النظامية التى يمكن أن تتولى الحكم من بعد الثورة، وهذه الكتلة الشعبية يكون على القوى المنظمة دائما أن تتصارع مع بعضها البعض فى جذب هذه الكتلة أو أجزاء منها لتقوى بها على القوى الأخرى فى موازين المشاركة فى السلطة الجديدة.
ويزيد الأمر تعقيدا أيضا، أن القوى المنظمة المشاركة فى إزاحة الوضع السابق، أنها فى علاقاتها مع بعضها البعض إنما تتعدل وتختلف توازناتها النسبية مع بعضها البعض، بعد إزاحة النظام السابق، ذلك أن الفعل الثورى عندما أزاح النظام القديم بأشخاصه وعلاقات نخبه، يكون ترك فراغا من شأنه أن يغير من التوازنات التى كانت قائمة بين قوى الثورة ذاتها، إن فراغ الحكم وتغير العلاقات السياسية والاجتماعية الناتج عن الفعل الثورى، من شأنه أن يغير بالإضافة أو النقصان أو التعديل فى مجالات القوة السياسية، بالنسبة لكل من قوى الثورة النظامية، فمن كان أكثر فاعلية فى تحطيم قوة النظام السابق ليس بالضرورة يكون الأكثر فاعلية فى تحديد أوضاع النظام الجديد، ومن كان أقل فاعلية فى ذلك التحطيم قد يكون أكثر تأهيلا فى تولى مراكز فى الدولة الجديدة، وهكذا فإن التوازنات بين قوى الثورة فى عمليات الإزاحة للنظام السباق تختلف عن توازناتها فى العمل السياسى التالى لهذه الإزاحة، بتغير الأحجام وباختلاف الأهداف وبتباين المؤهلات الفنية ونوع الخبرات المكتسبة.
وإن كل هذه التعقيدات تثير وجوه صراع أو بالأقل وجوه جدال واحتكاكات بين قوى الثورة التى تشاركت فى أفعال الإزاحة، وهو صراع يثور حول الأهداف المبتغاة من الثورة، وحول حصة كل من قواها فى المشاركات التالية ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوة ولتشكيل النخب الجديدة المسيطرة والتوازنات بينها. ونكون فى كل ذلك مازلنا فى إطار العملية الممتدة، وهذا الصراع الجديد يدخل فيه كل ما استجد من تعديلات وقد يصل إلى حد التشابك بين هذه القوى، وقد يكون أكثر هدوءا وأبطأ مسعى، لكنه فى كل الأحوال يكاد يكون حتميا عند تعدد القوى التى شاركت فى الثورة.
وهذا ما عرفنا من تتابع الثورات المصرية مثل فى تاريخها المعاصر، بدءا من محمد على فى 1805 إلى عرابى فى 1882 إلى وفد 1919 إلى ثورة 23 يوليو 1952 إلى ما لا نزال نحياه فى ثورة 25 يناير 2011.
ومشكلة هذا الصراع الناشئ عن المرحلة الثانية للثورة، أنه صراع تزداد حركته صعوبة وتميل إلى الحدة وطول المدة وصعوبة التوقع بفعل عوامل منها:
أولا: أن تكون قوى الثورة متقاربة فى تأثيرها وفاعليتها بحيث لا يملك إحداها أو بعضها إمكان الحسم السريع فى ترتيب أوضاع النظام الجديد.
وثانيا: أن تكون قواها الذاتية والنظامية قبل الثورة وأثناءها ليست من التبلور والتحدد بما يساعد على إمكان الحسم الأسرع، وذلك كثيرا ما يحدث عندما يكون الحراك الشعبى التلقائى المنضم للثورة أثناء شبوبها أكبر كثيرا من حجم القوى المنظمة التى أشعلت الثورة وأطلقت شرارتها الأولى، وفى هذه الحالة يكون الكثير من القوى النظامية ليس على بينة من حقيقة حجمه وفاعليته السياسية الحقيقية، ولا يعرف مدى قوته الذاتية معرفة أقرب إلى التحدد الكافى لحساب مدى طموحه فى المشاركة السياسية بعد مرحلة الإزاحة.
وثالثا: ألا تكون على بينة مما تعدل به موقعها السياسى وقدراتها الفعلية بعد إزاحة النظام السابق، وذلك بالنسبة لقدرتها الذاتية وقدرة غيرها من شركائها، ومن ثم ترتبك الحسابات السياسية ويصير الصراع السياسى بين هذه القوى أقرب للتكهن والتقديرات الظنية البعيدة عن الحسابات الدقيقة ذات الأبعاد المقدرة، ويصير كل من القوى المتصارعة إنما يتحسس قوته وقوة غيره أثناء عملية الصراع ذاتها بالتجربة والخطأ، ويفضى ذلك كله إلى شمول الموقف السياسى كله بغلاله من عدم التيقن وعدم إمكان التقدير والتوقع والحساب.
(3)
كانت مصر معبأة بالحالة الثورة من بضع سنوات قبل حدوثها فى 25 يناير 2011. وكانت النخبة الحاكمة محصورة فى عدد محدود جدا من رئيس الجمهورية وأسرته وبعض رجال الأعمال المحيطين بهم وعدد محدود من غير رجال الدولة القابضين على أجهزة الأمن والاقتصاد، وتحولت مصر إلى مجتمع تسيطر عليه هذه القلة القليلة جدا، تحكم سياساته وتسيطر على ثرواته وتفكك نظام دولته وتهدم أسس التطور الحضارى ذاتها، وهى فئة مغلقة على ذاتها تزداد مع الأيام ضيقا وانعزالا وشراسة.
وحرصا منها على دوام بقائها اتبعت سياسة التحطيم لأى تشكيل أو جهاز تنظيمى يمكن أن يتشكل فيه قرار خارج إرادتها، سواء من أجهزة المجتمع كالأحزاب أو النقابات العمالية والمهنية والجمعيات، أو من أجهزة الدولة ذاتها فى غير مجال حفظ الأمن الداخلى لهذه النخبة ف:ى مواجهة الشعب. لذلك فإن عموم السخط لم يكن يقلقها فى السنوات الأخيرة، لأنها أجهزت بالتفكيك على أية تشكيلات تنظيمية يمكن أن يتبلور فيها قرار قابل للتنفيذ ضد مصلحتها.
وقد سبق أن كتبت فى ديسمبر 2010 (1)
ما يشير إلى هذا الوضع وما هى الإمكانات للخروج منه وإلى المظان التى يمكن أن يبدأ منها الحراك الثورى من خلال ما هو ممكن ومتاح فى هذا الظرف المضيق:
«نحن عندما نرى ضعف الحركة الحزبية فى مصر وتهافتها الواضح، فإنما يقتضى الإنصاف منا ألا نرجع ذلك إلى أوضاعها الداخلية فحسب، ويتعين أن نعترف أن من أسباب هذا الوهن أن السياسة المتبعة على مدى سنوات وسنوات، خاصة فى العقدين أو الثلاثة الأخيرة، قد عملت على القضاء على هذه التشكيلات الاجتماعية، إذ إن الشعب لا يعد حقيقة ملموسة إلا بالتنظيمات التى ينظم فيها فئات وطبقات وتجمعات. والأحزاب لا تستطيع أن تكون لها حركة فاعلة فى الشأن السياسى إلا من خلال صلاتها بالتجمعات الشعبية العديدة الكائنة والموجودة بين الناس، سواء كانت هذه التجمعات التنظيمية ذات وجود تقليدى مثل القبائل والطوائف حيث توجد فى بلاد لسنا منها، أو تجمعات تنظيمية حديثة مثل النقابات والاتحادات العمالية أو الفلاحية أو الرأسمالية، وبغير هذه التشكيلات لا يتحول الرأى العام السياسى إلى قوة مادية».
ثمة تنظيمات مهنية عسكرية ومدنية، وهى ذات وجود ضرورى، لأن وظائفها الاجتماعية والمهنية لا يمكن أن تتحقق فى الحياة الاجتماعية الجارية إلا بهذا الوجود، مثل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وهى تنظيمات قادرة طبعا على الحركة المهنية والوظيفية فى المجال الوطنى الذى رسم لنشاطها، وهى تقوم بوظائفها المتخصصة المرسومة لها بالأسلوب الرتيب المعتاد، ولا تخرج عنه ولا تتجاوزه.
لكنها فى موقف حرج يحدث أو فى لحظة أزمة مهددة للمجتمع يمكن لأى من هذه المؤسسات أو بعضها أن يستخدم شبكتها التنظيمية لا فى أداء وظائفها العادية المرسومة، بل فى القيام بعمل تمليه الضرورة السياسية الملحة، وتتحول هذه التنظيمات من وظائفها الرئيسية الرتيبة إلى أداة استثنائية ترى أنها ترفع شرا أو تنقذ وطنا، وحالات ذلك معروفة فى التاريخ.
«وثمة تشكيلات تكاد تكون صغيرة الحجم من الناحية التنظيمية وضعيفة الأثر فى الحياة السياسية الجارية، ولا يكاد يحسب لها حسابا كبيرا فى توقعات المستقبل بالنسبة للأوضاع القائمة، ولكن فى أحوال أزمة محدقة أو انتفاضة غير منظمة، قد تتيح لأى من هذه التنظيمات ما يمكن أن تبلور حولها حجم شعبى مؤثر فى الحياة السياسية العامة، والتاريخ فيه من الأمثلة لهذه الحالات الكثير، وإن المطالعين لأحداث ثورة 1919 فى مصر بصورة تفصيلية يعرفون كيف كانت الجماعات الشعبية تجتمع فى تنظيمات محدودة النطاق وصغيرة الحجم، ثم لا تلبث أن تتقارب وتتجمع فى تكوينات أكبر. وهكذا».
وبين التصورين السابقين ما يمكن أن تثمر عنه حركة المستقبل من صور وأشكال وأساليب مستحدثة، ولا يمكن لمن يتابع الأحداث أن يتنبأ بهذه الاحتمالات، لأن حركة الحياة أغنى كثيرا مما تنحصر فيه المعارف السابقة والتجارب التى مضت، وأن الأزمات تولد طاقات لا تلبث أن تجتمع وتنحشد، ثم لا تلبث أن تبحث عن مخرج منها، أرأيت النبتة الصغيرة الخضراء كيف تجد طريقا إلى الشمس والهواء رغم ما يطبق عليها من الأحجار الكثيفة.
«إن المحافظين على الأمر الواقع يقاومون أى حراك يمكن أن يعارضهم، وهم فى صنيعهم هذا يستخدمون خبراتهم السابقة وتجارب التاريخ، إنهم يقمعون ما يخشون من حراك يكون معارضا لهم، لكنهم لا يعرفون من صور وأشكال هذا الحراك إلا ما سبق حدوثه، أما ما يثمر عنه الواقع الجديد من صور وأشكال جديدة لم تكن معروفة، فهم يفاجئون بها ولا يستطيعون مواجهته فى الوقت المناسب».
وقد أردت بهذا المقتطف الطويل أن أوضح صورة الوضع المأزوم الذى كانت عليه الحالة الثورية فى مصر قبيل الثورة، وأنه لم يكن من حقائق الوجود الملموس ما هو مرشح ومؤهل للإنجاز الثورى المأمول، وإن التطلع كان إلى حلول مستجدة واستثنائية يتجه إليها الرجاء لتوجد بالحراك الثورى نفسه ويتفتق عنها، ولهذا الوضع أثره من بعد فى مسار الثورة بعد إنجاز مرحلتها الأولى بإزاحة النظام القائم.
عقب نجاح ثورات الربيع العربي، و صعود نجم التيار الاسلامي، حضرت العلاقة بين الدين والدولة في الوطن العربي بقوة،و في خضم المعارك السياسية التي لا تنتهي بين القوى والاحزاب والحركات السياسية المصرية، يغوص المفكر والفقيه الدستوري المستشار طارق البشري في" حالة مصر ما بعد الثورة" شارحا لنظام لا تزال ملامحه تتشكل، من خلال ورقة قدمها فى الندوة التى عقدها مركز دراسات الوحدة العربية عن "الدين والدولة فى الوطن العربى" التى عقدت خلال الفترة من 15 ـ 17 أكتوبر فى تونس، والتي تنشرها "الشروق"على حلقات
(4)
الحاصل أن الحركة الشعبية التى فجرت ثورة 25 يناير كانت صاحبة السهم الأول فى إسقاط نظام حسنى مبارك، بدأت يوم الثورة ونمت من حيث الحشود الشعبية على نحو بالغ السرعة، فوصلت إلى ما يقدر ببضعة عشر مليونا فى المدن الرئيسية والأقاليم، بما أظهر للعيان استحقاقها للوصف الثورى، تماسكا وانتظاما وحشودا وتصميما وتناميا فى كثافتها وفى مطالبها عن إسقاط النظام.
إلا أنها لم يكن لديها القيادات التنظيمية المؤسسية التى يمكن أن تحيل الحراك الثورى إلى قوة منظمة يتولد عنها ما يمكن أن يتولى السلطة أو يحل محل النخبة الحاكمة المزاحة. والأحزاب المعترف بها رسميا ضعيفة لم تعرف لها مساهمة كبيرة فى أشكال الثورة ولا فى تحريك معتبر للثائرين ولا تنظيم فعال لهم. وقد أشعل فتيل الثورة جماعات شبابية محدودة العدد، وكان الاندفاع التلقائى هو المَعين وهو ما تحولت به شرارة الإشعال إلى لهب أرق النظام السياسى القائم، وإن تحول الشرارة من إمكان إشعال سيجارة إلى استطاعة إشعال حريق مدمر لأبنية ومنشآت يتوقف على حجم الوقود المتاح، وكاد ألا يكون له وجود تنظيمى مؤثر إلا جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه وجود وإن رجح الآخرين إلا أنه لم يكن بالحجم ولا بالقدرة التى تجعله يتحكم فى مسار الحركة الثورية.
وكان ثمة قيادات فكرية وثقافية ثورية مشهود لها بالوطنية والمكافحة، بخاصة خلال السنوات الست السابقة منذ سنة 2005، وساهمت مساهمة ذات شأن وغير مشكوك فى أثرها المعتبر، وساهمت فى تهيئة الحالة الثورية التى انفجرت شعبيتها الكاسحة من 25 يناير حتى 10 فبراير، إلا أن هذه القيادات لم تكن ذات روابط تنظيمية قادرة على التحريك الشعبى المنظم بقرارات تتخذ وتعليمات حركية تتبع وأهداف تنفذ، فهى لم تكون قادرة على بلوغ الثورة هدفها وهى إحلال حكم جديد محل الحكم المزاح.
وكان ثمة حركات احتجاج شعبى وتحركات اجتماعية حاشدة، عرفها عمال المصالح فى الكثير من أقاليم مصر ومدنها وموظفى إدارات ومصالح وطوائف اجتماعية، وذلك مدة السنوات الست أو السبع السابقة، وهى يقدر عددها بالمئات من حركات التجمع والاحتجاج والاعتصام، وكانت تتراوح مطالبها من المطالب الاقتصادية المتعلقة بالأجور والعمالة، وبين المطالب المتعلقة بالحريات والإفراج عن المعتقلين، وبين المطالب الفئوية الخاصة بالمساواة، وكل ذلك نمت به ثقافة التجمع والخروج والاحتجاج حتى صارت منتشرة.
وقد أرهص ذلك للحدث الكبير، ولكن كل هذه الحركات عندما حدثت كل منها إنما حدثت بشكل متناثر ومعزول بعضها عن بعض، ولم تستطع الأحزاب القائمة أن ترتبط بها وأن تشملها بروابط تنظيمية تمكن من تحول هذا الحراك الاقتصادى الاجتماعى إلى حراك سياسى لتنظيمات سياسية محدودة ولتتأهل به للحلول محل النظام الساقط فى السلطة.
لذلك فإن هذه الثورة الجماهيرية الحاشدة التى فاجأت القاصى والدانى وفاجأت صانعيها أنفسهم بحجمها الهائل وبتناميها المطرد وبتحديها إرادة حسنى مبارك ووعيها المصمم على هدف الإطاحة به وبنظامه، وبذكائها الجماعى فى اكتشاف كل محاولات التضليل وزيف الوعود غير الحقيقية، وبقدرتها على تصعيد الموقف السياسى والتمسك بأهدافها، وبحسها السلمى ومحافظتها على السلمية فى مواجهة عنف السلطة التى مارست ضدها القتل والتجريح، وبتمييزها بين العدو والصديق أثناء الحراك الثورى، بكل ذلك فهى لم تكن ذات قيادة مشتركة تعبر عنها وتتحدث باسمها، سواء من تنظيم واحد أو من عدد متحالف من التنظيمات.
ولعل ذلك كان من توفيق الله سبحانه لهذه الحركة فى مرحلتها الأولى، لأن عدم تبلور القيادة فى أشخاص معينين وفى زعامات وتشكيلات معروفة وسبق التعامل معها، وعدم وجود من يملك من هؤلاء اتخاذ القرار المسموع بالنسبة للجماهير، إن ذلك ساهم فى شل قدرة الحكومة على أن تتصل بمن تتشخص فيهم الحركة والثورة، للتعامل معهم بالقمع أو بالعزل عن القواعد أو بالتضليل بالشائعات أو إثارة الفتن بين بعضهم البعض.
وقد عُرف أن الحكومة بمستويات عالية تصل إلى رئيس المخابرات العامة الذى عين وقتها نائبا لرئيس الجمهورية حاول الاتصال والحديث ببعض من ظن أنهم ممثلو الحركة الثورية ولم تنجح مساعيه، وكان أحد أسباب ذلك أنه لم يكن لفرد أو لعدة أفراد ولا لجماعة معينة أن تدعى أنها تملك السيطرة على الحشود الثائرة أو التأثير الفعال فى حركتها.
ويبدو أن ما ساهم فى إنجاح الثورة فى إزاحة نظام الحكم القائم رغم غياب القيادات والتنظيمات القادرة على السيطرة على حركة الجماهير هو هذه القدرة التى لدى الشعوب فى أن تندرج فى الأزمات فى حالة شعورية واحدة ينجم عنها موقف واحد أو مواقف متجانسة ،سيما إذا كانت لا تعرف فروقا ثقافية عامة آتية من الاختلافات الطائفية أو القبلية أو الاقليمية.
لكن كل هذا شىء، أما الشىء الآخر فهو ما يتعلق بما يأتى بعد إنجاز ما اجتمع الناس عليه من إسقاط النظام السياسى والنظر فيمن يحل محله وما هى السياسات التى يتعين اتخاذها، كما أن السلطة السياسية فى الدولة هى تشكيل مؤسسى يجمع إرادات وينظمها ويصدر قرارات ويدفع أفعالا من خلال جماعات بشرية منظمة، وثمة قنوات لتجميع المعلومات وتشكيلات لدراسة الواقع الجارى ونظم قانونية أو عرفية لدراستها ثم إصدار القرارات بشأنها، وتوزيع مهام العمل والتنفيذ والثورة الشعبية بغيتها فى النهاية سلطة الدولة والإمساك بمؤسسة الحكم، ولا يستقيم تحقيق هذا الأمر مع وجود فراغ مؤسسى، لأن جهاز الدولة لا يحتمل الفراغ التنظيمى ولابد لمن يمسك به أن يكون له كيان تنظيمى، وهذا بالضبط ما لم يكن الفعل الثورى الحاصل يملك منه تنظيمات تمثل مجتمعة أو منفردة هذا الشمول الشعبى الحادث، وإن أقوى التنظيمات الشعبية الموجودة وقتها لم يكن يملك من الحجم التنظيمى الفعال ما يجعلها قادرة على ذلك.
لذلك تقدم الجيش لملء هذا الفراغ، والجيش مؤسسة نظامية تخضع لشرعية الدولة القائمة ولقراراتها، وهى فى التحليل النهائى تمثل عمود الارتكاز النهائى لأية دولة، وحركة الجيش الحاصلة أثناء الثورة كانت فى بدايتها حركة شرعية بالنسبة لنظام حسنى مبارك، فإن حكومة مبارك هى من استدعى القوات المسلحة للنزول فى الشوارع لمواجهة الحركة الثورية بعد أن عجزت الشرطة عن هذه المواجهة، وبعد أن نزلت القوات المسلحة إلى الشوارع وسيطرت على المدن الرئيسية بقرار شرعى صادر لها من رئيس الجمهورية حسنى مبارك، لكنها لم تنفذ المهمة المطلوبة منها، وامتنعت عن مواجهة الجماهير بالعنف، ولا يوجد فى الثقافة المصرية الشعبية ما يذكر أن القوات المسلحة المصرية واجهت جماهير المصريين بالعنف، ونتج عن ذلك أن الجماهير الثائرة السلمية استقبلت المصفحات بمشاعر الود منذ نزولها للشوارع، ولم يكن انضمام القوات المسلحة إلى الحركة الشعبية يستدعى تحركا مضادا لشرعية الدولة القائمة لأنها هى من استدعت هذه القوات للحركة، إنما كان هذا الانضمام يأتى بموجب قرار من قيادة الجيش المتحرك بالانضمام إلى الثورة. وهذا ما حدث فى 10 فبراير عندما اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام وفى غياب قائده الأعلى حسنى مبارك وأصدر البيان رقم واحد عن حرصه على الشعب المصرى ومكتسباته، وفي اليوم التالى أعلن تنحى حسنى مبارك عن الرئاسة فى 11 فبراير.
وسدت القوات المسلحة الفراغ الحادث فى الحركة الثورية من الناحية التنظيمية، لأنه أعلن تحقيق فعل الإزاحة للنظام وسيطر على الحركة بوصفه المؤسسى، وصار شريكا فى الثورة لأنه وفر بتشكله المؤسسى ما كانت القوى الثورية تفتقده وقتها.
(5)
سبقت الإشارة إلى أن ثمة قاعدتين سياسيتين شبه مطردتين، وهما: أن من يحقق الإطاحة بالنظام القديم هو من يكون مرشحا للحكم من بعده، وإن العبرة فى ذلك بالقوى السياسية المنظمة التى تكون لها تشكيلات قادرة على إصدار القرارات وعلى الفعل التنفيذى لها، وبهذين الأساسين يمكن النظر فى أحداث ما بعد الإطاحة بنظام مبارك، لان المشهد السياسى الذى تتابعت حلقاته من بعد الإطاحة يدور حول تبين ما هى القوة أو القوى السياسية التى ستتولى الحكم منفردة أو بالمشاركة.
القوة المنظمة الأولى هى قوة جهاز الدولة المصرى، ويتعين الإشارة إلى أن هذا الجهاز كانت له مشاركاته فيما عرفت مصر من ثورات فى تاريخها المعاصر، وأولها ثورة المصريين بين 1800 و1805، وكانت مشاركة بين الحركة الشعبية تحت قيادة أزهريين وتجاريين وبين فصائل من القوة العسكرية متمثلة فى محمد على. ثم ثورة 1881 ـ 1882 التى قامت مشاركة بين القوات المسلحة برئاسة أحمد عرابى وبين جماهير مصرية عبر عنها ما عرف بالحزب الوطنى وقتها، وثورة 1919 لم تشارك فيها المؤسسة العسكرية لأن كتلتها الأساسية كانت موجودة فى السودان منذ أعوام 1896 ـ 1899، وبقيت هناك حتى خروج الجيش المصرى من السودان بإقصاء من الانجليز فى سنة 1924، ولكن جهاز الدولة المصرى المدنى شارك فى هذه الثورة بإضراب شامل له أفقد الانجليز القدرة على السيطرة على حكومة البلاد فسارعوا بالاعتراف باستقلالها فى 1922م. ثم ثورة 25 يناير الأخيرة التى بدأت بفعل شعبى ثورى ثم حسمت وقائعها حركة القوات المسلحة فى 10 فبراير، وهى ثورة هدفها الأساسى بناء التشكيلات الديمقراطية الحقيقية النزيهة المعبرة عن الشعب المصرى، فهى شعبية فى بدء اشتعالها وفى هدفها وشاركت فيها القوات المسلحة معبرة عن جهاز الدولة المصرى.
وجهاز الدولة فيما نعرف يقوم بنوعين من المؤسسات حسب أصل تشكيله الحديث، نوع يتصل بالشأن السياسى من حيث تقدير المواقف واتخاذ القرارات، ويتمثل أساسا فى رئاسة الجمهورية والوزراء وفى المجال النيابية. والنوع الثانى يقوم فى الأساس بوظائف مهنية بعيدة نسبيا عن التصدى المباشر للعمل السياسى، وهما فى الأساس القوات المسلحة والقضاء، وقد قام حسنى مبارك ونظامه بإضعاف أجهزة الدولة المتعلقة بغير حفظ أمن النظام الذى يرأسه وعمل على تفكيها، لأنها كانت جميعها قد بُنيت فى عهد جمال عبدالناصر على أساس شمولية إدارتها للمجتمع المصرى بالنسبة لإدارة الاقتصاد والخدمات والمرافق وغيرها.
وكان حرص نظام مبارك على تغيير هذه الوظائف ونقلها إلى النشاط الخاص لصالح النخبة الحاكمة الطفيلية، كان مقتضاه تفكيك روابط أجهزة الدولة، كما أن مقتضى السيطرة الفردية للحاكم على الدولة توجب على الرئيس الفرد أن يفكك كل ما هو دونه من مؤسسات العمل حتى لا تكون عنصر ضغط على إرادته الطليقة ولتكون أسلس قيادا له. وذلك فيما عدا طبعا أجهزة الأمن التى تصير تحت إشرافه المباشر هو والنخبة المرتبطة به.
لذلك صارت مؤسسات الدولة السياسية مفككة وضعيفة، والمؤسسات غير السياسية بعيدة عن النشاط السياسى، وكان أحد وسائل التعامل معها هو شغلها بمشروعات وأعمال بعيدة عن تخصصها المهنى الوظيفى، فلما انهارت دولة حسنى مبارك وأطيح معها بالمؤسسات السياسية، سواء الرئاسة أو الوزارة أو المجال النيابية، بقيت المؤسسات غير السياسية أصلا وهى الجيش والقضاء، وفى خلال أزمة الحكم التى تولدت مع الحراك الثورى تحول الجيش بقيادته المهنية التقليدية إلى العمل السياسى سدا للفراغ السياسى الحاصل كما سبقت الإشارة، وبدأنا نلمح فى القضاء نزوعا إلى التحرك السياسى من خلال الدعاوى المرفوعة أمامه.
ويلاحظ أن قيادة القوات المسلحة التى تحركت فى هذا الشأن السياسى كانت قيادة مهنية بحتة لم تتمرس فى أساليب العمل السياسى ولم تتراكم لديها خبرات سابقة فيه، لأنه كان ممنوعا عليها بحزم وصرامة الاشتباك فى العمل السياسى ولو بإبداء الآراء فيه، وكانت تتكون من قيادات عسكرية صرفت حياتها كلها فى العمل المهني بعيدا عن الخوض فى الشأن السياسى، وبلغت فى مهنتها أقصى ما يصل إليه الطموح المهنى من رتب وظيفية وفى آخر العمر المهنى، وألقيت عليهم المهمة السياسية مع الثورة بغير خبرة ولا وقت لاكتساب الخبرات فى مرحلة عمرية يصعب فيها أن يخوض الإنسان فى التجربة والخطأ ليتعلم ما لم يسبق له الاتصال به من معارض، ومن هنا نلحظ ضعف الأداء السياسى الواضح لهذه المؤسسة عندما استلمت السلطة بغير إعداد مسبق حلا لأزمة وطنية حلت.
(6)
أما القوة المنظمة الثانية فهى جماعة الإخوان المسلمين، وهى تمثل القوى المنظمة الأساسية فى النشاط السياسى الأهلى غير الحكومى، لما لها من أبنية تنظيمية تعتبر الأقوى فى مجال النشاط الأهلى فى مصر، من حيث العدد ودرجة الانضباط التنظيمى والاتساق الثقافى السائد بين صفوفها، وقد ساهمت الجماعة فى العمل الشعبى الذى شكل الجسم الأساسى للثورة الشعبية، وهى إن لم تكن من أطلق شرارات الثورة والدعوة بالتحريك لها، إلا أنها كانت بعد ذلك ذات حراك شعبى دار بدرجة من الانضباط ينبئ عنها سلوك يجمع بين إنكار الذات بعدم الإشارة إلى نشاطهم منسوبا للجماعة مع الاستعداد لتقديم التضحيات، فكان تشكلهم التنظيمى خلالها يفوق أى تشكل تنظيمى لأية قوة حزبية مفردة أو جماعة سياسية أخرى.
ولكن جماعة الإخوان المسلمين فى ثورة 25 يناير، لم تكن كما كان الوفد مثلا فى ثورة 1919م كانت قوة سياسية فعالة بما لا يقارن معها فصيل سياسى أهلى آخر، ولكنها ليست قوة حاكمة، أى ليس لها من درجة القوة ما يمكنها من أن تقود الثورة أو يكون لها القرار الحاسم فى مسيرتها وفى تزكية أى من المواقف السياسية التى تجد. هى ليست مثل وفد 1919 فى مصر، ولا مثل حزب المؤتمر فى الهند أو حزب الكومنتانج أو الحزب الشيوعى فى الصين بالنسبة للثورة التى حدثت فى كل من هذين البلدين. فهى ليست قائدة وليست ذات أغلبية حاكمة، وإن كانت ذات أغلبية مؤثرة لابد أن يعمل حسابها، وهى إن استطاعت من بعد أن تصل إلى الحكم فلابد أن يكون ذلك بمشاركة غيرها لضمان استقرار هذا الوصول.
وفى هذا الصدد ينبغي استدعاء الخبرة التاريخية لمصر، وإدراك ما يعتبر من الخصائص من هذه الخبرة. فإن وفد 1919 بوصفه تنظيما شعبيا أهليا استطاع أن يكسب من مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات الأولى التى جرت بعد الثورة بأربع سنوات فى نهاية 1923، وفقا لدستور ونظام انتخابات أعده أعداء الوفد وقتها سواء الملك أو الأحرار الدستوريين، استطاع الوفد أن يكسب أكثر من 90٪ من مقاعد هذا المجلس. ومع ذلك لم تستمر حكومة الوفد فى الحكم أكثر من عشرة شهور استقالت بعهدا وحل مجلس النواب، وخلال ثلاثين سنة من عمر هذا الدستور فى مصر حتى 1952، جرت عشرة انتخابات منها ستة انتخابات نزيهة حصل الوفد على الأغلبية فيها جميعا بما لا يقل عن 70٪ التى حصل عليها فى 1950، ومع ذلك لم يتح له الحكم طول الثلاثين سنة إلا نحو سبع سنين وشهور ولا تزيد أقصى مدة متصلة قضاها فى كل مرة عن سنتين.
وهذا مثال أرجو به أن أوضح أن مراكز القوى السياسية فى المجتمع ليست فقط تتمثل فى الأغلبية الشعبية ولا فى التنظيم الحزبى الشعبى الواسع المنضبط، وإن القوة السياسية الفعالة المؤثرة، قد تكون مرتكزة على الأجهزة الدولة وتستمد عنفوانها منها، وقد تكون متمركزة فى وسائل الإعلام وأجهزته، بما يهيئ لها تأثيرا كبيرا على صياغة الرأى العام وإبراز مسائل سياسية يفيدها إثارتها أكثر من غيرها مع تشكيل وجها النظر لدى الأغلبية غير المعنية بالشئون السياسية وبما يرتب ردود فعل تلقائية سابقة التجهيز، وقد تكون هذه القوة السياسية متمركزة فى رجال الأعمال بما لديهم من تأثير على جمهور مرتبط بأعمالهم، فضلا عما يوجهون إليه من فوائض دخولهم ما يدعم أنشطة مؤثرة فى العمل السياسى.
«عقب نجاح ثورات الربيع العربى، وصعود نجم التيار الإسلامى، حضرت العلاقة بين الدين والدولة فى الوطن العربى بقوة، وفى خضم المعارك السياسية التى لا تنتهى بين القوى والأحزاب والحركات السياسية المصرية، يغوص المفكر والفقيه الدستورى المستشار طارق البشرى فى «حالة مصر ما بعد الثورة» شارحا لنظام لا تزال ملامحه تتشكل، من خلال ورقة قدمها فى الندوة التى عقدها مركز دراسات الوحدة العربية عن «الدين والدولة فى الوطن العربى» التى عقدت خلال الفترة من 15: 17 أكتوبر فى تونس، والتى تنشرها «الشروق» على حلقات..
الحاصل أن ما أسفر عنه المقياس الانتخابى من تأييد شعبى لجماعة الإخوان المسلمين، لا يتأتى من النظر فى نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجارية فى 19 مارس 2011 بعد الثورة، التى كانت تتمثل فى 77.2٪ للمؤيدين للتعديلات و22.08٪ للمعارضين لها، لأن هذه التعديلات كانت تتعلق فقط بأحكام دستورية تتوخى بناء مؤسسات سياسية للدولة بطريق ديمقراطى نزيه، سواء المجلسان النيابيان أو رئاسة الجمهورية، مع ضمان نزاهة الانتخابات، وإن تنتخب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، تختار هى من المجلسين المنتخبين بطريقة ديمقراطية، ولا تكون هذه الجمعية مشكلة بالتعيين من غير منتخبين. ولم يكن بالأحكام المستفتى عليها أى نص يشير ولو من بعيد إلى ما يتعلق بهوية الدولة، ولا بالشعارات والنداءات التى تميز التشكيلات الدعوية الإسلامية، ومن ثم فإن أغلبية 77.2٪ وإن شملت الإسلاميين إلا أنها لم تقتصر على مؤيدى التنظيمات الدعوية الإسلامية، وليس من معيار يمكن به تحديد مدى أثرهم فى هذا الاستفتاء.
إنما ما يمكن أن يرشد إلى حجم التأييد الشعبى الذى حصلت عليه جماعة الإخوان هو انتخابات مجلس الشعب التى جرت فى نوفمبر وديسمبر 2011، وكان نظام الانتخاب يجرى بالقوائم الحزبية بالنسبة لثلثى مقاعد كل من مجلسى الشعب والشورى وبالانتخاب الفردى بالنسبة للثلث الباقى، وقد تقدم الإخوان فى هذه الانتخابات من خلال جبهة ضمت إليهم بضعة أحزاب أخرى صغيرة، وكانت النتيجة أن مجموع ما حصلت عليه هذه الجبهة من مقاعد مجلس الشعب كلها هو 47٪، وللإخوان من هؤلاء ما تبلغ نسبته 40٪ من مجموع المقاعد، وذلك رغم أن الانتخابات جرت ولم يمض على الثورة أكثر من عشرة شهور.
والمقياس لحجم التأييد الشعبى لجماعة الإخوان هو انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن انتخابات الجولة الأولى استوجبت إعادة الانتخاب لعدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم وإذا كان مرشح الإخوان صاحب الأغلبية النسبية الأكثر فإنها ظلت فى حدود الخمسة ملايين صوت بين أربعة مرشحين تراوحت أصوات كل منهم بين ما يدور حول الخمسة ملايين والأربعة ملايين، ثم جرت الإعادة بين مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسى وبين الوزير السابق الفريق أحمد شفيق فحصل فيها الدكتور مرسى على الأغلبية المطلقة بما لا يجاوز 52٪ من الأصوات ويدور فى حدود الملايين الخمسة، وكان مجمل أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات يبلغ نحو 23.6 مليون شخص، وقد تولى رئاسة الجمهورية بما يمكنه من استعمال سلطة الدولة فى تشكيل الوزارات وغير ذلك.
ولكن يلاحظ أن منصب رئاسة الجمهورية وإن مكَّن شاغله من السيطرة على السلطة فى الدولة، فإن أمر السيطرة على جهاز أو أجهزة قديمة وتتكون من تشكيلات متنوعة عسكرية وأمنية ومصالح وهيئات تتراوح فى القدم والتخصص، ليست السيطرة تكون بسهولة أن يتولى فرد رئاسة فينصاع له الجميع وإن أظهروا الطواعية والانضباط، سيما عندما يكون هذا الفرد أو الأفراد من غير تشكيلاته الأساسية التى تعودوا على التعامل معها، وسيما إذا كان من غير ذوى الخبرة فى إدارة نوع العمل البيروقراطى المؤدى ومن كان خارج إطار التشكل الثقافى الوظيفى المعتاد لدى العاملين بهذا الجهاز أو هذه الأجهزة، وسيما إن كانت مدة رئاسته مؤقتة أو من غير المتيقن استمرارها استمرارا معتبرا.
وخلال مطالعاتى لثورة 1919 وما بعدها فى مصر، بدا لى أن أدرس مسألة جذبنى إليها طرفاتها، وهى كيف تحولت الثورة إلى نظام، وما هى الآليات وأنواع الصراع التى جرت فى هذا التحول، وقد ظهر أن جهاز دولة عميق الجذور والسلطات كالجهاز المصرى إنما يشبه القلعة، ومن يحكم القلعة من الناحية التنظيمية إنما يترجح نجاحه فى حكمها وإحكام السيطرة عليها بقدر ما يكون من رجالها، وإن القلعة من خصائصها أن من دخلها من خارجها إما أن يسيطر عليها فتدافع عنه وتحميه وإنما أن تسجنه فيصير حبيسا بها، وهذا ما فسر لنا تردد سعد زغلول زعيم الثورة والسياسى ورجل الدولة المخضرم، فى قبول الحكم بعد أن حصل حزبه على 90٪ من مقاعد المجلس النيابى، ثم استقالته بعد عشرة أشهر فقط، وهو لم يصنع شيئا خلال هذه الأشهرة العشرة، وإنما كان يتصرف كما لو كان لا يزال فى المعارضة فيعلن موافقته واعتراضه ومواقفه دون أن يتخذ إجراء عمليا. والقلعة إما أن تحمى أو تحبس حسب نوع العلاقات التى تقوم بين من دخلها وبين رجالها. وإن أجهزة الدولة تملك مد رئيسها بالمعلومات التى يتخذ قراراته على أساسها وهى من يملك طريقة تنفيذ قراراته، وبهذين الأمرين تكون أحاطت بالسيد الرئيس.
ولكننى أوضح أنه فى حدود التوجه الإسلامى لجماعة الإخوان المسلمين التى تولى أحد رجالها رئاسة الجمهورية فإن النزوع الإسلامى الذى يظهر فى ممارسة رجال أجهزة الدولة لا يكون فى الأساس مصدره هذه الرئاسة، لأن الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى بين الغالبة الغالبة من المصريين هى ثقافة إسلامية أو أن مرجعيتها إسلامية، وهذا يظهر بوضوح من انتخابات النقابات المهنية فى مصر، إذ إنها عندما تجرى بنزاهة ترجح ذوى الاتجاه الإسلامى من بين ما يكون أغلبية مؤثرة من الفائزين فى الانتخابات، والمهنيون فيما هو معروف هم من يكونون الفئة التى تمثل العمود الفقرى فى كل أجهزة الدولة وفى سائر التخصصات وهم أعضاء فى النقابات المهنية بنسبة مؤثرة. وأن هذه الكوادر لديها توازناتها الفكرية بين ما يمليه عليها مهنتها وبين ما يحوط ذلك من ثقافة عامة سائدة مستمدة من المرجعية الإسلامية.
ومن بين عناصر هذه القوة الثانية جماعات السلفيين، وهى لم تكن تؤدى دورا سياسيا ملحوظا قبل الثورة، ولم يلحظ لها بوصفها السلفى نشاط فى الفترة الأولى من الثورة التى أدت إلى الإطاحة بنظام حسنى مبارك، ولم يلحظ لها بدء نشاط سياسى فعال فى الشهور الأولى من الثورة، ولكنها ظهرت بوصفها قوة سياسية ذات نفوذ يجب الاعتبار به بعد ذلك. لقد كان نشاطها الأول نشاطا دعويا، ولكن الأوضاع السياسية والاجتماعية تؤدى أحيانا إلى أن التنظيمات التى تنشغل بشئون اجتماعية أو ثقافية كالجماعات الدعوية أو الصوفية أو النقابية أو غيرها، قد تلجئها الأوضاع العامة إلى أن تتحول بشبكاتها التنظيمية ورجالها من وجوه نشاطها المعتادة إلى وجوه أنشطة تستجد، وهنا يكون الظهور قويا لأنه يصدر عن وجود تنظيمى سباق ذى شأن، ولكنه قد ينطوى على الكثير من التردد فى الاستجابة لأنواع العمل الجديد بسبب الجدة وقلة الخبرة فى المجال المستحدث، وهذا ما كان من الجماعات السلفية وأظهرها الآن حزب النور والجماعة الإسلامية والجهاد وغيرها من التنظيمات.
وإن ما أتاح للجماعات السلفية أن تظهر سياسيا وتقوى نسبيا هو تأخر إجراء انتخابات مجلس الشعب عن موعدها الذى كان شبه محدد فى يونيو 2011 فتراخت الانتخابات حتى نوفمبر وديسمبر التالى؛ لأن هذه الفترة أتاحت فرصة من الزمن لتحول السلفية الدعوية إلى النشاط السياسى، فكسب السلفيون فى هذه الانتخابات نحو 25٪ من المقاعد بمجلس الشعب، وأكسبهم هذا الفوز عزوتهم السياسية فيما بعد.
ولكن يلاحظ أن الحراك السلفى السياسى ليس متجانس الأنشطة والمواقف، وهو يتسم بقلة خبرة فى المجال السياسى إلا من جماعات وشخصيات لا تمثل الطابع الغالب والمستمر له، وتتراوح المواقف السياسية بين العديد من التنوعات وقد انعكس ذلك فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إذ توزع التأييد الانتخابى بين عدد من المرشحين المتنافسين مما أضعف من عزوتهم الانتخابية وخصم من بعضها البعض، وهى إن كان لها قوة حشد سريع، فإن التنظيم المنضبط الذى يمكن من العمل الدائب طويل المدى لم يختبر بعد.
وخلاصة ذلك كله أن هذه القوة